El karzazi
TABOUASSAMTE
 TABOUASSAMTE
TABOUASSAMTE
Ksar TABOUASSAMTE is one of the oldest villages in Tafilalet . Its history is well known to the majority of people. Its name was as narrated to us "alzobeir"; it was the village that stands against the "alalwiyyin" in sijilmassa. The new name comes as our ancestors narrated to us from the name of a princess; they told us that there was in the past a king in this village and he had had a daughter, her name was "tabou3" when this princess fasted Ramadan for the first time, people started saying "tabou3samt" "tabou3samt" which means "tabou3 fasted" so the village named by this name from that time.
Concerning its location, TABOUASSAMTE occurs in the center of "sfalat". In the north there is "keurlan" in the west there is"Hoiara" in the south there is "Irara" and the east there is "Sidilrazi".
TABOUASSAMTE is considered the biggest village in "sfalat". It contains all the basic institutions, when you are coming from RISSANI, you'll find the oldest farm which is called "lbizana" then after it there is the preparatory school of TABOUASSAMTE in the same side and "ljama3a" which is still inoperative, few meters from it but on the other side there is the Mail, then in front of the village there is the Hospital of "sfalat".
Another feature of the noblest of TABOUASSAMTE is its huge mosque which was built only in 2005. The village also is famous by its beautiful houses outside it. When you are inside one them you will feel as if you are in one of the houses of the city. There are more than twenty houses, which are rare or absent in other villages. Most of the owners of those houses are those who travel abroad to foreign countries especially Spain, French and Italy.
Finally; I will not exaggerate if I say that TABOUASSAMTE is the beautiful village in "Sfallat", it is as some "Fillalians" who has no partiality say: 'it is the capital of "Sfalat"'.
 Commentaires textes : Écrire
Commentaires textes : Écrire
محمد العم&# 1585;وا& #1610;
المَدْرَسـةُ العِلْميَّــــةُ بــِسِجْلِمَاسّة
بقلم
الأستاذ البحاث الشيخ
أبي سلمان
محمد العمرواي
بسم الله الرحمن الرحيم
المشهور أن سجلماسة من تأسيس بني مدرار الخوارج أواسط القرن الثاني الهجري، وقد حدد كثير من المؤرخين ذلك بعام: 140 هـ .
وذكر ابن أبي محلِّي: أن تأسيسها كان على أيدي العرب الفاتحين عام : 40 هـ، ثم وسعها بنو مدرار، فكانت عاصمة لتلك الدولة، إلى أن استولى عليها الفاطميون ملوك القيروان، فأدرت عليهم أموالا طائلة باعتبارها مركزا تجاريا مهما في طرق القوافل المتجرة في السودان، ولما قامت دولة المرابطين … رجعت إلى حكم المغرب وظلت عامرة كذلك أيام الموحدين والمرينيين إلى أن خربت قبيل قيام دولة السعديين([1][1]) .
ويقول محمد بن الحسن الوزان – في سبب خراب سجلماسة - : " وقد استولى بنو مرين على هذا الإقليم، بعد اضمحلال مملكة الموحدين، وعهدوا بحكمه إلى أقرب الناس إليهم، وخاصة أبناءهم، وظل الأمر كذلك إلى أن مات أحمد ملك فاس، فثار الإقليم، وقتل أهل البلاد الوالي، وهدموا سور المدينة، فبقيت خالية حتى يومنا هذا، وتجمع الناس فبنوا قصورا ضخمة، ضمن الممتلكات ومناطق الإقليم، بعضها حر، وبعضها خاضع للأعراب " ([2][2]) .
فسجلماسة- إذن - تعتبر من أعظم حواضر المغرب التاريخية، وأشهر مدنه التجارية والعلمية، وقلما يخلو مؤلف في التاريخ العام أو الخاص ، وكذا كتب الجغرافية، من ذكر سجلماسة - بسطا أو اختصاراً - باعتبارها مدينة سياسية واقتصادية وعلمية .
وإن الناظر في التقلبات السياسية في المغرب على مدى تسعة قرون أو يزيد، ليدرك بسهولة أن سقوط سجلماسة في يد أمير أو قائم يطلب الملك، يكون مفتاح سقوط باقي الحواضر واستسلام جميع القرى .
ولسنا بسبيل تأريخ أحداث سجلماسة السياسية، فذلك مسطور مشهور، وإنما غرضنا هنا التعريج على جانب عظيم الأهمية في تاريخ هذه المدينة يكاد يطويه النسيان، ألا وهو الجانب العلمي .
إن مما لا يختلف فيه ، أن المدن الإسلامية، كانت تؤسس - أول ما تؤسس - على التوازن والتكامل.فالمسجد الجامع – أولا - والسوق – ثانيا – ثم تأتي المرافق الأخرى تباعا .
ولم تشذ سجلماسة عن هذه القاعدة، فكان مسجدها الجامع مدرسة عامرة بالعلم، ومعهداً مليئاً بالدرس والتحصيل، إلى جانب مدارسها العديدة، التي تستقبل الطلاب الوافدين عليها من الآفاق البعيدة .
يقول الناصري : "ولما كانت سنة سبع وأربعين وأربع مائة، اجتمع فقهاء سجلماسة ودرعة، وكتبوا إلى عبد الله بن ياسين ويحيى بن عمر وأشياخ المرابطين كتابا…" ([3][3]) .
وقال الأستاذ إدريس بن أحمد الفضيلي : " إن مدينتها العظمى.. هي قاعدة بلاد المغرب – قبل فاس – ودار الملك منه، قد عمرت قبل حلول الأدارسة بهذا القطر المغربي بقريب من أربعين سنة، وذلك عام : 140 –على القول المشهور – ولم يتقدم لأهلها كفر – أي بعد إسلامهم الأول على خلاف كثير من القبائل والأنحاء - ولم تزل من ذلك الوقت عامرة آهلة بالعلماء والصلحاء والأخيار، وهي أول بلاد درّس بها العلم بالمغرب، فقد ذكر القاضي عياض في { المدارك } أن أحد الأعلام بها- سماه -، أخذ عن الإمام مالك بالمدينة، ورجع إليها ودرس بها العلوم…" [4][4] .
ويقول ابن حوقل: " وسجلماسة، مدينة حسنة الموضع، جليلة الأهل، فاخرة العمل.. وأهلها قوم سراة مياسير، يباينون أهل المغرب في المظهر والمخبر، مع علم وستر وصيانة وجمال واستعمال للمروءة، وسماحة ورجاحة، وأبنيتها كأبنية الكوفة، إلى أبواب رفيعة على قصورها مشيدة عالية "[5][5].
ويقول العلامة الكبير محمد بن المختار السوسي – في ترجمة العلامة عبد الرحمن بن محمد الجشتيمي - : " درج المترجم في عصر لا تزال فيه المعارف منتشرة، وقد تولى زعامتها أصحاب الحضيكي وأمثالهم، ممن يأخذون إذ ذاك، عن التمجروتيين والسجلماسيين والفاسيين والمصريين" .[6][6] " فهناك حواضر في المغرب وأمصار وقرى ورباطات وزوايا،كانت مصابيح متلألئة في سماء المغرب برجالها وعلومها ومدارسها، أصبحت في خبر ليس وكان.وما (نكّور ) و( البصرة ) و ( الدلاء ) و ( سجلماسة ).. إلا أمثلة لما جناه الإهمال على تاريخ المغرب الفكري والسياسي.."[7][7] و يقول محمد بن الحسن الوزان الفاسي،المعروف بليون الإفريقي : " كانت سجلماسة مدينة متحضرة جدا،دورها جميلة، وسكانها أثرياء بسبب تجارتهم مع بلاد السودان، وكان فيها مساجد جميلة، ومدارس ذات سقايات عديدة، يجلب ماؤها من النهر ".[8][8] ولقد انتقلت تلك المدارس بعد خراب المدينة الكبيرة إلى القصور والمداشر،فكان في كل قصر من القصور الكبيرة مدرسة أو مدرستان ،بالإضافة إلى المسجد الجامع، وربما اقتصرت الدراسة على المسجد في بعض القصور .
قال الأستاذ: إدريس بن أحمد الفضيلي :" ولم تزل مشحونة بالعلماء والصلحاء …وذلك قبل نزول الأشراف بها، وأما بعد حلولهم بها فلا تجد قصرا من قصورها، ولا مدينة من مدنها، ولا قرية من قراها، إلا وفيه من العلماء والصلحاء، وأهل الفضل وطلبة العلم والقراء، من لا يحصى كثرة، ولا ينحصر بعدّ. والغالب على أهلها التواضع والسكينة والوقار وطلب العلم والأدب ".[9][9]
وقال الفقيه ابن أبي محلّي السجلماسي المولود عام:967 :" وبخطة القضاء اشتهر نسبنا فنعرف بأولاد القاضي، وزاويتنا بزاوية القاضي، ولم تزل بقية العلم في دورنا –خصوصا- دار أبي "[10][10].
ويقول محمد بن المختار السوسي – في ترجمة أحمد بن المبخوت…- وكان يسكن في ( أمسيفي ) بـ ( الغرفة ) حيث مباءة العلم من قديم "[11][11].
وقد اشتهر على الألسنة-قديما وحديثا-أن مدينة فاس هي مركز العلم بالمغرب وموطنه، يقول محمد بن جعفر الكتاني: " .. فهي – أي فاس – في القديم والحديث، دار علم وفقه وحديث وعربية، وفقهاؤها هم الفقهاء الذين يقتدي بهم جميع فقهاء المغرب"[12][12].
ولعمري إن ذلك لصحيح، ولكن على الجملة لا التفصيل، ذلك أن علماء سجلماسة لم يكونوا يسلمون بالإمامة في العلم لأهل فاس –دائما- وإنما كانوا يساجلونهم ويردون عليهم بل ويتهمونهم – أحيانا - بالقصور في الفهم والضعف في العلم .
يقول العلامة محمد بن الطيب القادري –في ترجمة أبي مروان عبد الملك التجموعتي السجلماسي-: "ووقع النزاع بينه وبين بعض علماء فاس، حتى قال في بعض رسائله يخاطب بعض خواصه: " أما بعد فقد اتصل بنا مكتوبكم الأنور، من أنه –صلى الله عليه وسلم- لم يفارق الدنيا حتى علم كل شئ يلتمس الإفادة بحقيقة العلم النبوي، وقد أجبنا به، بحضرة النخبة العليا…من أنه –صلى الله عليه وسلم- لم يفارق الدنيا حتى علم كل شئ، استغربه واستنكره طلبة فاس، وبالغوا في التشنيع بين عوام الناس، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ضياع العلم وفقد أهله، هيهات!! ما هذا بعشك فادرجي، وأنى لمن أنكر الخوض في هذه المسائل؟ وغالب ما يتعاطاه وشيوخه من قبل في الدروس ((ندب لقاضي الحاجة جلوس )) ..إلخ..[13][13] .
وهذه المساجلة، وتلك المناضلة، تدلك على ما لهذه البلدة من مكانة، وما لعلمائها من منزلة، وإن لعلماء فاس لفضلاً وشرفاً .
ولقد سجل التاريخ – وما لم يسجله أكثر – أسماء كثيرين من فحول العلماء المنتسببن إلى هذه المدينة، والغارفين من بحار علومها .
يقول ذ. عبد العزيز بن عبد الله : "وقد أنجبت المنطقة مئات العلماء، هاجر بعضهم إلى الشرق، وبعض أقطار المغرب العربي، مثل المفتي علي بن عبد الواحد بن محمد السجلماسي الذي كان مفتياً بالجبل الأخضر ".[14][14]
وسنحاول-مع قلة المصادر المختصة بهذا الجانب- أن نطلع القارئ الكريم على ما كانت تزخر به هذه المنطقة من معارف وعلوم، مبتدئين بعلوم القرءان لكونها أشهر علوم تداولها السجلماسيون .
علوم القرآن الكريم
إن عكوف أهل سجلماسة على قراءة القرءان وإقرائه مما لا يكاد يحتاج إلى إثبات، لشهرة ذلك واستفاضته، بل لو قلنا بتواتره لما جاوزنا الحد في الوصف .
ولقد تخصصوا في إتقان التلاوة وإحكام الأداء، وبرعوا في التجويد أيما براعة، حتى صاروا المرجع في ذلك، والمعتمد عليهم فيما هنالك، وقلما تجد منهم حافظا للقرءان، لا يحفظ{ الدرر اللوامع في أصل مقرإ الإمام نافع}، أو نصيبا منها على أقل تقدير، مع حسن التطبيق –كما أسلفنا – بخلاف غيرهم .
يقول أبو العلاء إدريس بن أحمد الفضيلي: " ولهم – أي أهل سجلماسة – اليد الطولى في تجويد القرءان ومخارج الحروف، وقراءة الروايات من السبع إلى ما ما بعده مع التفنن في سائر العلوم "[15][15].
ويقول محمد بن المختار السوسي –في ترجمة أبي عمران موسى بن ييبورك بن الحسن المتوفى عام 1108-: " وهذا هو الصحيح، لأني وقفت على إجازة لموسى، في كراسة كتبها له عبد الرحمن بن أبي القاسم بن محمد بن القاضي ابن أبي العافية، وقد استهلها بخطبة حسنة، ثم قال : " أما بعد : فأن أولى ما بذلت فيه مصونات الأعمار، وأعملت فيه الأذهان الثاقبة والأفكار، وأبلي في خدمته الجديدان: الليل والنهار،كتاب الله العظيم، الذي هو جماع العلوم الربانية ونظامها، وملاك الشريعة الحنيفية وقوامها، وكمال خير الدنيا والآخرة وختامها - إلى أن قال- : فأجزته بالقراءات السبع عن شيخنا عبد الرحمن بن عبد الواحد السجلماسي، عن شيخه محمد بن أحمد بن محمد الشريف الحسني، وقد عرض علي المجاز أبو عمران موسى قصيدة الشاطبي –يعني{ حرز الأماني } عرضا جيدا، فحدثته بأسانيدها عن عبد الرحمن بن عبد الواحد السجلماسي، كما عرض علي { الدرر اللوامع في أصل مقرإ الإمام نافع } عرضا جيدا فحدثته بالإسناد المذكور، وكذا { مورد الظمآن }[16][16].
ويقول محمد بن الطيب القادري – في ترجمة أحمد بن مبارك..- : " جمع قراءة السبعة، قبل دخوله لفاس، على ولد خالته، الإمام الكبير..سيدي أحمد الحبيب..".
وقد كان الشيخ الحبيب متصدرا للإفادة العلمية في سجلماسة، يقول القادري: " وأخذ عنه جم غفير من أهل سجلماسة وغيرها". [17][17]
ولقد طفحت تراجم السجلماسيين بالقول: " إنه- أي من يترجم له- يتقن القراءات، ويجود القرءان تجويدا حسنا"، ولقد اشتهر على ألسنة أهل هذا الفن : أن اللوح يكتب في الجبل( جبالة ) ويحفظ في سوس ويقرأ في تافيلالت.
وليس المراد بذلك أن أهل كل جهة لا يحسنون سوى ما ذكر، بل المراد تخصص كل جهة بأمر من تلك الأمور مع مشاركتها للجهة الأخرى فيما تخصصت فيه، ذلك أننا نجد لأهل سجلماسة اهتماما بالرسم المصحفي لا يكاد يقل عن اهتمامهم بالتجويد، بل يعتبرون أنفسهم أئمة في ذلك .
ومما يدل على ذلك قول أحدهم-ويعزى لسيدي محمد التهامي بن الطيب، كما أخبرني بذلك سيدي الوالد، بارك الله في حياته-:
يا طالبا غادياً لمكناس
|
|
بلغ سلامي لأهل فاس
|
وللشيخ الإمام محمد التهامي بن الطيب الغرفي السابق الذكر الذي كان بقيد الحياة عام : 1247 هـ منظومة في الرسم، تعد من أجمل ما كتب في هذا الصدد وهي من محفوظات جل حفاظ القرءان في المنطقة، وقد عثرت على نسخ منها عند أبناء الشمال، فرأيتهم يعتنون بها أتم عناية، واسمها نصرة الكتاب كما قال ناظمها:
سميته بنصرة الكتاب بينت فيه مختار الأصحاب
إن اهتمام أهل سجلماسة بالدراسات القرآنية يضرب بجذوره في أعماق التاريخ الإسلامي، ويرجع إلى أواخر القرون المفضلة على أقل تقدير، فقد ذكر ابن فرحون أن لأبي محمد بن أبي زيد القيراوني{ رسالة في تلاوة القرءان} أرسلها إلى أهل سجلماسة.[18][18]، وأبو محمد توفي عام : 386 هـ .
ولأهل سجلماسة مساهمات مكتوبة في هذا المجال لا شك أن أكثرها ضاع مع ما ضاع من تراث هذه الأمة، والباقي يدل على الذاهب .
ففي التجويد هناك كتاب لأبي العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي المتوفى عام: 1175 هـ اسمهُ{ عرف الند في أحكام المد} توجد منه نسخ مخطوطة بالخزانة الحسنية[19][19].
وفي القراءات نجد شرحاً لأحمد بن مبارك اللمطي السجلماسي المتوفى عام: 1156 هـ على القصيدة الموسومة بـ{ الدالية في تخفيف الهمز لحمزة وهشام} ، وهي منظومة لأبي عبد الله محمد بن المبارك المغراوي السجلماسي المتوفى عام : -1092 -، وهذا الأخير ولد بفاس [20][20] .
وفي التفسير هناك كتاب { تفسير القرءان الكريم} للهلالي سابق الذكر[21][21].
وفي فن الرسم نجد{نصرة الكتاب } السالف الذكر، وتوجد منه نسخ مخطوطة عديدة لدى الخواص، يقول ناظمها في أولها:
قال عبـيد ربه المحتجـــب
|
|
محمد التهامي ابن الطيـــــب
|
وهي منظومة جديرة بالتحقيق، والنشر نرجو الله أن يقيض لها من طلاب العلم من يقوم بذلك، وقد بلغني أن أحد طلاب الدراسات العليا فعل ذلك، ولست على يقين من هذا .
اشتهر على ألسنة بعض العلماء أن المغرب بلد فقه وفروع، وليس بلد حديث وأصول .
قال الذهبي : " وأما بجاية، وتلمسان، وفاس، ومراكش، وغالب مدائن المغرب: فالحديث بها قليل، وبها المسائل"[22][22].
وهذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه، وإن كان قائله الحافظ الذهبي، وقد بينت بعض ذلك في مقال سبق نشره في{ رسالة المعاهد الغراء }.
ولقد اعتذر الحافظ الذهبي عن قالته تلك -أو كاد- حينما قال……[23][23].
ويحق لنا أن نتساءل كيف برع المغاربة في الفقه وهم لا يعرفون مبناه؟! أم كيف أتقنوا الفروع وهم لا يعرفون أصولها من القرءان والحديث ؟!
إن المغاربة – حالهم كحال إخوانهم المشارقة – اهتموا بالحديث اهتمامهم بالفقه والقرءان والتفسير وغير ذلك من علوم الشرع .
وعيب المغاربة منذ زمن بعيد أنهم لا يكتبون ،ولذلك طوى معظمهم النسيان، فصاروا لا يعرفون .
يقول العلامة محمد بن جعفر الكتاني : " ولقلة اعتناء أهل هذا المغرب بالتاريخ ضاع أكثرهم، وخفي على كثير من الناس جمهورهم ومعظمهم"[24][24] .
وإن كثرة نسخ الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث في الخزائن المغربية، كخزانة القرويين وغيرها لتدلك على مدى اهتمام المغاربة بالحديث وعلومه، وإن الناظر في شروح الصحيحين بله الموطإ، ليعلم علم اليقين مقدار استفادة علماء المشرق من علماء المغرب في هذا المجال، ولو جرد فتح الباري - وهو من أعظم شروح البخاري - من أقوال ابن بطال، وعياض، والداودي، والقابسي، وابن العربي، والغساني، والأصيلي، والباجي، وابن عبد البر، وابن أبي جمرة، وأبي الحسن ابن القطان … لما بقي فيه إلا القليل، وأنت على علم بأن عمدة النووي في كتابه { المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج } على القاضي عياض .
ليست بنا حاجة إلى التعصب للمغاربة قومنا - لأن كل المسلمين قومنا - ولكن البحث العلمي يقتضينا أن نعيد لعلماء هذا القطر اعتبارهم، وأنا مع د. الحسين آيت سعيد في قوله :" إنهم قلة"[25][25]، ولكنها قلة متقنة تقوم مقام الفئة الكثيرة، ( فالنِّطَافُ العِذَابُ تروي لا البحر) .
ولنعد إلى علماء سجلماسة - فلقد جنح بنا القلم فيما لم نقصد إليه - فنقول:
إنهم كما اهتموا بالدراسات القرآنية اهتموا كذلك بالدراسات الحديثية، واشتهرت بذلك بيوت، تخصصت في الحديث أو قاربت ذلك، مثل بيت التجموعتيين، في ( زاوية القاضي )، وبيت الهلاليين، في ( قصر سيدي إبراهيم بن هلال )، وإن كانت شهرة هذا البيت في كل العلوم – ولا سيما الفقه- لا تقل عن شهرتها في الحديث .
ولقد احتفظ لنا التاريخ بتراجم جملة من محدثي هذه الديار تدلنا على ما كان يحظى به الحديث وعلومه من عناية واهتمام .
ومن أراد معرفة المزيد، فلينتظر بحثنا الخاص بطبقات المحدثين المغاربة، ففيه الكثير من ذلك، نسأل الله أن يعيننا على إكماله .
ولم يكن اهتمام السجلماسيين بالحديث دراية فقط أو رواية فقط، وإنما كان اهتمامهم بالأمرين معاً، وسترى في البرنامج الدراسي الذي كان معتمدا في هذه الديار إلى وقت قريب صدق ذلك .
وقد ذكر الحافظ الذهبي – في ترجمة الإمام مالك-رحمه الله-: " أن لأبي الحسن بن حبيب السجلماسي { مسند الموطإ }"[26][26] .
علما الأصول: أصول الدين، وأصول الفقه
يقصد بأصول الدين: علوم العقائد، وما ينحو منحاها .
ولا شك أن دراسة علوم العقائد وتدريسها من أولى الأولويات، وآكد المهمات، ولا يتصور وجود حركة علمية في بلدة إسلامية، دون أن يكون تدريس العقائد على رأس القائمة .
ويقصد بأصول الفقه- كما هو معروف في مظانه - :" معرفة دلائل الفقه إجمالا،وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد".
وبالنظر إلى تضلع علماء سجلماسة في الفقه ، وتقدمهم في نوازله وقضاياه، يتضح أنهم كانوا على دراية بأصوله، وعلى معرفة بقواعده، ومع ذلك فقد كان اشتغالهم بهذين العلمين متأخراً بالنظر إلى اشتغالهم بعلوم أخرى .
وقد ذكر الأستاذ أبو العلاء إدريس الفضيلي- في ترجمة الحسن بن قاسم ( الداخل )- : "وكان إماما عالما، صالحا زاهدا ورعا، أول قادم بعلمي البيان والأصول لسجلماسة".[27][27].
وهذا القول يصح على قول من قال: " إن دخول الحسن بن قاسم للمغرب، كان في المائة السادسة "، وهو قول ضعيف لا يعتد به. والصحيح أن دخوله كان في أواخر المائة السابعة.[28][28]
وقد ذكر ابن الزيات – في ترجمة أبي الفضل بن النحوي المشهور صاحب {المنفرجة}-: "..لما قدم سجلماسة، نزل مسجد ابن عبد الله، ليدرس أصول الدين وأصول الفقه، فمر عليه عبد الله بن بسام، وكان من رؤساء البلد، فقال: " ما العلم الذي يقرئه هذا الإنسان" ؟ فقيل له: أصول الدين وأصول الفقه، وكانوا قد اقتصروا على علم الرأي، فقال: أرى هذا أراد أن يدخل علينا علوما لا نعرفها، فأمر بإخراجه من المسجد، فقام أبو الفضل من مكانه، فقال: " أمت العلم أماتك الله هاهنا…".[29][29].
وهذا النص يدل على أن أبا الفضل ابن النحوي، أول من أدخل هذه العلوم لسجلماسة، وأن ذلك كان قبل مجيء الحسن بن قاسم بما يقرب من خمسين سنة، لأن ابن النحوي توفي عام- 513 - بعد خروجه من سجلماسة بمدة، إلا أن يقال: إن ابن النحوي أول من أتى بها لكنه لم يتمكن من تدريسها، فيكون الحسن بن قاسم أول من تمكن من نشرها وتدريسها، فكانت له الأولية من هذه الجهة .
وكيفما كان الأمر، فإن أهل سجلماسة تلقوا هذه العلوم، واعتنوا بها- ولا سيما أصول الدين- حتى جاوزا الحد في بعض ذلك كما يدل عليه كلام بصري زمانه، أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي – رحمه الله – في محاضراته[30][30] .
و للعلامة سيدي أحمد بن مبارك اللمطي السجلماسي، إسهامات مهمة في علم أصول الفقه تؤكد ما انتحيناه، منها : { شرح على جمع الجوامع}و{ رد التشديد في مسألة التقليد}و{ تأليف في دلالة العام على بعض أفراده}بل إن له جولات وصولات في هذا الميدان مع الأصولي الكبير الإمام القرافي-رحمه الله تعالى- .[31][31]
لقد برع علماء سجلماسة في الفقه، واشتهروا به، كاشتهارهم بالإقراء أو قريباً من ذلك .
يقول أبو العلاء إدريس بن أحمد الفضيلي الحسني: " أما الفقه وأحكام القضاء فلا يجاريهم أحد فيه ولا يباريهم، حتى كانت القضايا ترفع إليهم من سائر أقطار المغرب، وكانت – ولا زالت - بها بيوتات عظيمة مشهورة بالولاية والعلم والدين، منهم بيت: ( الهلاليين ) و ( الإبراهيميين ) و ( الإماميين ) و( التجموعتيين ) و ( الميزاريين ) وغيرهم، كـ( الغرديسيين ) و ( المغراويين)[32][32] .
والفقه قي سجلماسة قديم وقد سبقت الإشارة إلى تلمذة أحد أبنائها للإمام مالك – رحمه الله- .
وقال ابن فرحون- في ترجمة أبي القاسم حماس بن مروان المتوفى عام : 303- : " معدود في أصحاب سحنون، سمع منه صغيرا… وسمع بمصر من محمد بن عبد الحكم وغيره، وبإفريقية من حماد السجلماسي.."[33][33] ولعل حمادا هذا هو الذي ترجمه القاضي عياض، فقال: أبو يحيى حماد بن يحيى السجلماسي، يروي عن ابن الماجشون وهو أول من قدم بفقه ابن الماجشون القيروان، سمع منه سحنون، وكان شيخا صالحا تاجرا، وكان في كتبه تصحيف كثير لم يكن يقوم بها، سمع منه عامة أصحاب سحنون[34][34] .
وقال ابن فرحون – أيضاً - في ترجمة أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، أثناء ذكر الآخذين عنه- : " ومن أهل المغرب: أبو علي بن أمدكتو السجلماسي..[35][35]" .
وذكر ابن الزيات – رحمه الله –في ترجمة ابن حمّودة- وهو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن موسى- : " من أهل سجلماسة ، وبها مات في حدود-612-من أهل البيت وسلفه أهل خير وصلاح وعلم، وجده محمد بن موسى، ممن أخذ عن أبي محمد بن أبي زيد القيرواني "[36][36] .
وإن الناظر في كتب تاريخ الفقه، وكتب تراجم رجاله، ليجد أن فقهاء سجلماسة يحتلون حيزاً كبيراً، وأن أقوالهم وفتاويهم تؤخذ بالتقدير والإجلال .
ويكفي أن نشير هنا إلى أحد أئمتهم المتأخرين، والذي يمثل هذه المدرسة خير تمثيل، إنه أبو سالم وأبو إسحاق، إبراهيم بن هلال بن علي، السجلماسي، مفتيها وعالمها، الفقيه الإمام العالم الحافظ الصالح المتفنن النظار، حلاه في{ دوحة الناشر} بـ "شيخ الفتيا وإمام أهل التقى، العالم العلم القدوة، كان هذا الشيخ أشهر من أن يذكر لفضله وغزارة علمه واتساع باعه وعلو مقامه، وقد وقفت سنة –81 – على تأليف له ذكر فيه فهرسة أشياخه، وما حصل عليه من فنون العلم وإجازته فيها، ولا غرو أن من وقف عليه يقضي بعظيم قدره وعلو منصبه، وأنه فريد عصره وأعجوبة دهره، وذكر لي غير واحد من الفقهاء أنه شرح ابن الحاجب، أعني { مختصره الفرعي} شرحاً عجيباً إلا أنه لم يوجد،… مع إجماع أهل العصر على إمامته وفضله وولايته.. وبالجملة فابن هلال من العلماء الأعلام وأكابر مشايخ الإسلام".[37][37]
أخذ عن ابن آملال، والإمام القوري مفتي فاس، وغيرهما .
له نوازل وفتاوي مشهورة .
وله { الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير} يقول في أوله-بعد الحمدلة، والتصلية المعهودتين- : "أما بعد فإني لما نسخت أجوبة الشيخ الفقيه…أبي الحسن الصغير.. فوجدتها أجوبة شاملة، على قواعد المذهب ومنهاجه جارية، جمة الفوائد، مشتملة على جواهر من العلم وفرائد، صادرة من فقيه محصل…قيدها عنه وجمعها تلميذه الشيخ ابن أبي يحيى التسولي التازي، غير أنه لما قيدها بقيت غير مرتبة، بل تركها كذلك مختلطة، فعزمت على ترتيبها… وذيلت جلها بأقوال علمائنا، ونصوص أئمتنا وفقهائنا…وترجمته بـ{ الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير }[38][38] .
و{ شرح مختصر خليل } لم يكمل .
وله على خطبته شرح حافل سماه { نور البصر في شرح خطبة المختصر } ، تطرق فيه إلى أصول الفتيا وقواعدها، وهو المرجع عند العلماء في هذا الباب .
و{ شرح البخاري في أربعة أسفار} اختصر فيه شرح الحافظ ابن حجر.
و{ الأجوبة} .
و{ اختصار الديباج لابن فرحون، مع زيادات عليه } .
وكتاب { المناسك } .
كان آية في النظم والنثر ونوازل الفقه، حتى لقب بباز النوازل، وله في النوازل كتاب حافل رتبه علي بن أحمد الجزولي، الذي يقول في مقدمته : "وبعد فإني لما رأيت الطلبة بدرعة المحروسة، يتشوفون كثيرا لنوازل الشيخ العالم العامل سيدي إبراهيم ..وكانت غير متجانسة، بل جمعت حسب الورود والوقوع، نهضت مني القريحة الساكنة لترتيبها حسب الإمكان.."[39][39].
وعلى الغلاف{ أجوبة ابن هلال }وفي كلام مرتبها ورد ذكر النوازل صريحا، ولابن هلال كتاب الأجوبة كما مر فهل كما كتاب واحد مسمى باسمين أو هما كتابان هذا أحدهما ؟ وإذا كان كذلك، فأيهما هذا؟ أما المذكور هنا فهو " النوازل " بلا شك ، فقد تكرر ذكر لفظ ( النوازل ) داخل الكتاب مراراً ، وجاء في آخره ( انتهت نوازل العلامة سيدي إبراهيم بن هلال رحمه الله التي رتبها علي بن أحمد الجزولي " ، وغالب من ترجم لابن هلال ذكر له كتاب " النوازل " وكتاب " الأجوبة " ، فلا يبعد أن يكون كتاب " الأجوبة " مستقلاً عن " النوازل " ، والله تعالى أعلم .
توفي ابن هلال عام : 903 هـ [40][40].
والعجب كل العجب من الحجوي حيث لم يعرج على ذكر ابن هلال، مع ذكره لأبي الحسن الصغير، وإشادته بعلمه وتقدمه، بل وذكره له على أنه من المجددين في القرن السابع، حيث يقول: " لا غرابة إذا عد مبعوثا في رأس القرن السابع في قطره "[41][41]، وبين أبي الحسن وابن هلال نسب في العلم لا ينبغي إهماله، ويأبى الله إلاّ أن يتفرد بالكمال .
العلوم العقلية
لم يكن أهل سجلماسة ليقتصروا في دراستهم وتدريسهم على علوم النقل وحدها، لأن " أسباب حصول العلم للخلق ثلاثة:الحواس السليمة، والخبر الصادق، والعقل" [42][42]، ولأن العلوم النقلية تتوقف على العلوم العقلية ، والعكس صحيح .
من هنا كانت للعلوم العقلية سوق نافقة في سجلماسة .
يقول القادري – في ترجمة الشيخ أحمد الحبيب- : " الولي الشهير العالم العلامة الزاهد الكبير.. ووصفه تلميذه أحمد بن عبد العزيز بالمتضلع من المعقول والمنقول.."[43][43] .
ويقول في ترجمة أحمد بن مبارك..: "..له تبحر في المنطق .. "[44][44]وله في هذا الفن {طرر} وضعها على شرح الشيخ سعيد قدورة على{ السلم} للأخضري.وهي مطبوعة في ضمن مجموع يطلق عليه :{ الشروح الأربعة} والمنطق هو رأس العلوم العقلية كما لا يخفى .
ويقول القادري في ترجمة أحمد بن عبد العزيز - : " كان-رحمه الله- إماما في تحقيق العلم، من بيان و.. ومنطق وهندسة..وألف كتبا عديدة..منها: شرح على أرجوزة سيدنا الجد، الذي سماه { الزواهر الأفقية على الجواهر المنطقية}، وبالغ فيه في التحرير والإتقان، وأتى بغاية التحصيل والشأن " [45][45] .
ويقول فيه الحجوي: " ومن أجل تآليفه، شرحه لمنظومة القادري في المنطق، - طبع بفاس- قل أن يكون له نظير،استقى من بحره من جاء بعده" [46][46] .
وقد افتتح المؤلف كتابه بقوله – مما يدل على علو مقامه، وجميل براعة استهلاله -: " الحمد لله الذي شرف بالمنطق الفصيح والنظر الصحيح نوع الحيوان العاقل، وعرف أولي البصائر المنورة والسرائر المطهرة بما اتخذوه عند هجوم المعضلات وجموح المشكلات من أمنع المعاقل، والصلاة والسلام الدائمان على سيدنا محمد الذي أوضح الله به المحجة، وأيده بساطع البرهان وقاطع الحجة، وعلى آله الذين لا يعرف بالحد فخارهم الظاهر، ولا يقدر بالقياس مقدارهم الباهر، وعلى أصحابه الذين عكسوا بالجهاد قضايا أعداء الدين، ونقضوا مبرم عقود الأحزاب المعتدين.." [47][47] .
فها قد بان لك بما ذكرنا أن العلوم العقلية كان لها رواج في تلك الديار .
وبما نقلناه عن الحجوي في {فكره السامي} أن علماء سجلماسة كانوا أئمة في تلك العلوم، يستقي منهم من يأتي بعدهم، وقد تم المقصود، فلا حاجة إلى الإطناب .
تعتبر علوم اللغة من نحو وصرف وبيان ومعاني وغير ذلك، من العلوم المهمة في الدراسات الشرعية، فمما لا شك فيه أن فهم القرءان والسنة فهما صحيحا متوقف على فهم قواعد اللغة وإدراك أسرارها .
ومن هنا نجد اهتمام علماء الإسلام في مختلف العصور باللغة العربية:- قواعدها وآدابها ومفرداتها- .
ولقد عرفت هذه العلوم في سجلماسة ازدهارا كبيرا، وانتشارا عظيما، وتبوأ أهلها الإمامة في بعض فروع هذه العلوم، من أمثال أبي محمد القاسم بن محمد بن عبد العزيز الأنصاري النٌّجار، السجلماسي الدار، - كان حيا عام : - 704- الذي كان إمام النقاد البلاغيين في عصره .
يقول الأستاذ علاّل الغازي: " ولننتقل الآن من الجانب الفلسفي، لنجد أنفسنا أمام علم كبير من أعلام النقد والبلاغة. الذين خطوا لأنفسهم طريقا خاصا امتاز بمنهجه العلمي السليم، الذي انفرد به عن الدارسين "، " فأخرج الدرس البلاغي والنقدي من فوضى التحديد والتحليل وفقر المصطلح، إلى وضعه في إطار ( العلم ) و( الصناعة ) أكثر مما عهدنا عند النقاد العرب"[48][48] .
وإذا كان لأهل سجلماسة اهتمام بعلوم اللغة جملة، فإن اهتمامهم بالنحو كان أوضح وأشهر، وقد وصف كثير منهم بالإمامة في ذلك .
يقول محمد بن الطيب القادري، ومحمد بن جعفر الكتاني- في ترجمة أبي الحسن علي بن الزبير السجلماسي المتوفى عام : 1035- : " فقيه نحوي لغوي، مشارك، علامة فهامة، إمام النحاة في عصره، ومحقق علماء دهره، كان ممن أجمع على جلالته وتمكنه في العلوم العربية، وكان كثير الحفظ لشواهد العرب والاطلاع على أخبارهم، وله المهارة القوية في اللغة، وكان إذا أورد المسائل النحوية يورد لها شواهد عديدة لا يجدونها في الكتب المتداولة، وكان يحفظ التسهيل وغالب شروحه… أخذ عنه جماعات.. كسيدي عبد القادر الفاسي، ومحمد بن أبي بكر الدلائ، ومحمد بن ناصر الدرعي، وغيرهم من الشيوخ الكبار.." [49][49] .
ويقول أبو علي الحسن اليوسي في{فهرسته}- وهو يترجم لشيخه أبي عبد الله محمد بن محمد التجموعتي- : " قرأت عليه معظم ألفية ابن مالك في النحو.. وله تحقيق في مهمات النحو.." [50][50] .
ويقول علال الغازي في أبي محمد السابق الذكر: " وفي كل لحظة تظهر شخصيته بوضوح بين الأعلام، كسيبويه، وابن جني والفارسي وابن خالويه والأخفش ومن ضاهاهم.."[51][51] .
ويقول العباس بن إبراهيم – في ترجمة محمد بن محمد بن أبي القاسم الشريف الحسني السجلماسي المتوفى عام –988-_ : " الفقيه الخطيب المشارك، النحوي المتفنن. له تقييد على ألفية ابن مالك..[52][52]" .
والأمثلة كثيرة ومتعددة ..بل لقد ذكر الفيروز آبادي: أن الخفاف السجلماسي، له شرح على {الكتاب} لسيبويه،[53][53] ولكنه لم يذكر شيئا عن الخفاف يعرف به .
وقد ذكر السيوطي هذا الاسم منسوبا إلى الأندلس .[54][54] ولست أدري أهما شخصان مختلفان؟ أم هو شخص واحد نسب إلى سجلماسة تارة وإلى الأندلس أخرى؟ ومثل ذلك يقع كثيرا لأسباب موضوعية، كأن يسكن المترجم بالبلدين، أو يكون المولد ببلد، والمنشأ أو الإقامة ببلد آخر، وغير موضوعية،كغلبة الأندلس على المغرب، وشهرتها بالعلم دونه، فينسب المؤرخون كل نابغة إلى الأندلس.." [55][55] .
وعلى كل حال، فقد ظلت هذه العلوم متداولة، واستمر الناس على دراستها وتدريسها، وامتلكوا ناصية اللغة، وقاموا بشرح ما يحتاج إلى شرح لغوي من كتب الفقه أو الحديث أو غيرهما كما فعل أبو عبد الله محمد بن منصور بن حمامة المغراوي السجلماسي، في شرحه غريب اللغة في { الموطإ} و{ صحيح البخاري}و{ الشهاب القضاعي} و{ المدونة } للإمام سحنون، و{ الرسالة} لابن أبي زيد. و{ المقامات} للحريري [56][56] .
وعلى ذكر المقامات يجدر بنا أن نشير إلى ما ذكره حاجي خليفة : من أن ممن شرحها أبو العباس أحمد بن عبد المومن القيسي الشريشي. – ت 619 هـ – وله عليها شروح، منها شرح يقول فيه حاجي:" اقتصر فيه على شرح غريب اللغات ولم يلتفت إلى ذكر المحاضرات، لما سأله أهل سجلماسة أن يشرحها لهم بأسهل ما يمكن من العبارة، إذ لغتهم بربرية، فشرحها شرحا مجردا وممزوجا".[57][57]
ومع ما في هذا الكلام من عدم الدقة .-حيث جعل تبسيط العبارة بسبب بربرية اللغة - فإنه يوضح مدى اهتمام السجلماسيين باللغة العربية :- قواعد وآدابا ومفردات- .
وفي القرن الثاني عشر يتصدى العلامة الموسوعي، الشيخ أحمد بن عبد العزيز الهلالي السجلماسي {للقاموس المحيط}للفيروز آبادي، فيشرح مصطلحاته ويوضح مشكلاته بكتاب سماه {إضاءة الأدموس، ورياضة النفوس، من اصطلاح صاحب القاموس} ، يقول في مقدمته- بعد الحمدلة والتصلية-: " أما بعد: فقد حصل لي بحمد الله من مطالعة القاموس واستقرائه، ومباحثة الأفاضل عند قراءته وإقرائه، ما يستحسنه النجيب، ويستعظمه الأريب. من اصطلاحه العجيب، وصنيعه الغريب، فجمعته بعون الله في هذا الجزء، وسميته…وذيلت به ما من الله به علي من { فتح القدوس في شرح خطبة القاموس} وبنيته على ثلاثة أركان..إلخ [58][58] .
وكما كانت سجلماسة مباءة للعلماء، يتخرجون منها فيشع نورهم في الآفاق البعيدة منها والقريبة على السواء.فلقد كانت - أيضاً - على مدى عصور، مقصدا للطلاب، ومحطا لرحال العلماء الوافدين عليها للاستزادة من العلم أو لتدريسه بربوعها .
فهي -كما وصفها –بحق – الإدريسي في { نزهة المشتاق }-" كثيرة العامر، وهي مقصد للوارد والصادر" ، ولتتضح لك - أخي القارئ - الصورة أكثر، أضع بين يديك البرنامج الدراسي، للمدرسة السجلماسية في أمسها القريب. الذي احتفظ لنا به أحد الطلاب الوافدين عليها قصد الدراسة والتحصيل العلمي، من ( الساقية الحمراء ) الواقعة بأقصى جنوب المغرب، لترى إلى أي مدى كان الاهتمام بالعلوم عظيماً، والانكباب على تحصيلها قوياً .
قال العلامة محمد بن محمد بن صالح السجلماسي نجاراً، الصحراوي منشأ الروداني دارا –في ترجمة شيخه أحمد بن عبد العزيز الهلالي السجلماسي:
"كنا نقرأ عليه في ا ليوم والليلة خمسة عشر نصابا، من خمسة عشر كتابا،فيملي علينا تفسيرها كلها من حفظها، بفصيح بيانه وبليغ لفظه،… وكنا نبدأ في القراءة بعد حزب الصبح بنصاب من التفسير من{البيضاوي} أو{ الجلالين} أو غيرهما، نسرد منه ربع حزب أو أكثر بحسب الوسع والتيسير، ثم نتبعه بنصاب من كتب أحكام التجويد، إما { الدرر اللوامع} أو{ الحرز} أو{ مقدمة ابن الجزري} .
ثم يتبع القرءان بالحديث، فنقرأ نصابا من{ الموطإ } أو {صحيح مسلم} أو غيرهما .
ثم نتبعه بنصاب من كتب اصطلاحه، من {ألفية العراقي} أو {الطرفة} أو غيرهما .
ثم نصاب {مختصر الشيخ خليل} نقرأ منه قدر ثمن حزب لا نجاوزه .
ثم نتبعه بنصاب من {جمع الجوامع} لابن السبكي في أصول الفقه، فهذه الستة قبل الزوال….فنقرأ بين الظهرين نصابا من التوحيد، من {كبرى السنوسي} غالبا أو {صغراه} أو {مقدمته} .
ثم نتبعه بنصاب من {مختصره في المنطق} .
ثم نختم بشيئ من كتب التصوف، {شرح ابن عباد على الحكم} أو {سنن المهتدين} أو {منهاج العابدين}.
فهذه ثلاثة فنون بين الظهرين، فنصلي العصر، ونقرأ نصابا من {الخلاصة} أو {الفريدة} أو {التسهيل} .
ثم نصابا من {التلخيص} للقزويني، …
ثم بعد حزب المغرب نقرأ بين العشاءين نصيبا من {الرسالة} أو {المرشد المعين} وآخر من {صغرى السنوسي} .
ثم بعد صلاة العشاء نقرأ صورا من الميراث، وعشرين بيتا من {التحفة العاصمية}…وكان –رضي الله عنه- يخص الخميس بقراءة الفنون القريبة كالحساب والتوقيت بالآلة كالاصطرلاب، والربع المجيب وبالحساب كـ{روضة الأزهار} و{اليواقيت} و{المعونة} و{المقنع} ونحوها والعروض [59][59] .
تلك-إذن- معالم المدرسة السجلماسية في أمسها البعيد والقريب على السواء، وقد قال علامة سوس: محمد بن المختار السوسي- في ترجمة المولى الرشيد بن محمد بن عبد الرحمن العلوي، المولود عام : 1245. والمتوفى عام : 1330 في أول المحرم منها- :
" وقد وصفه من كان يعرفه أتم معرفة، أنه كان يحفظ كتاب الله،. ومعه نبذة من العلوم، ويصاحبه العلماء دائمان وقد كان العلماء إذ ذاك كثيرين هناك، مثل سيدي محمد الطاهر..المتوفى عام : 1364 ه. والفقيه سيدي محمد بن الشيخ الايراري العلامة المتوفى عام : 1372.هـ، وأخوه الحاج محمد تقدمت وفاته، والفقيه سيدي محمد بن العربي الغرفي. توفي عام : -1376-في شعبان منها. والفقيه القارئ سيدي الهاشم الشريف، توفي عام: 1370، وله {مؤلف في التجويد}… ثم قال – بعد أن ترجم لثلاثة عشر رجلا آخر من مشاهير العلماء-: " هؤلاء النقاية ممن كانوا يحضرون مجلس المترجم، وكانت الدراسة لا تنقطع أمامه في سرد البخاري، والشفاء، واللطيف الكبير الذي يجمع له الناس –خصوصا- يوم الأربعاء " [60][60] .
أما اليوم، فقد أجدبت الأرض وأقحلت.وأقفرت من العلوم وخلت. وصارت كما قال القائل:
|
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا |
|
أنيس ولم يسمر بمكة سامر |
ولولا بقية من شيوخ، منهم من قضى نحبه،-أمثال:شيخ الجماعة سيدي محمد بن المدني، والفقيه النوازلي سيدي محمد ابن الحنفي الودغيري، والعالم الموسوعي الألمعي شيخ شيوخنا سيدي عبد الرحمن اليحياوي الجعفري، و الفقيه الحاج المختار الغرفي نزيل الغرفة وإمام تلك الجهة، ود. محمد تقي الدين الهلالي، الذي طارت شهرته في الآفاق، و.. - ومنهم من لازال يكابد ويجاهد - أمثال أخينا وقدوتنا الشيخ المربي القدوة، أبي عطاء الله سيدي عبد الله بن محمد بن المدني، وشيخنا ورفيقنا في الغربة، سيدي محمد الأمراني العلوي - عرف بابن التقي..- لقلنا بأن هذه البلاد لم يكن للعلم بها ذكر، ولا للعلماء بها وجود .
وليأذن لي القارئ الكريم، في أن أعطي الكلمة الختامية للعلامة محمد بن المختار السوسي – رحمه الله- فهو يقول :
".. والقارئ يرى أن تلك الجهة، غنية بمواد التاريخ من كل ناحية، فأين المعتنون بهذا الجانب المغربي، ليفيدونا ويفيدوا التاريخ، عن صفحات إن لم تتدارك اليوم، فستضمحل أبد الآبدين، فثورا يا أبناء ( تافيلالت) - سجلماسة- كما نعهده فيكم تحت الغيرة ثوروا، فأنا أضمن لمن ثار منكم أن يخلد أروع الصفحات عن تلك الجهة المباركة، وهل ( تافيلالت ) –سجلماسة- إلا بركات على بركات"[61][61].
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
[1][1] انظر: تقييد في التعريف بسجلماسة.مخطوط:م،م.رقم24.36.نقلا عن حاشية لمحمد حجي. ومحمد الأخضر. على ( وصف إفريقية) للوزان. 2/121.ون-أيضا-( الاستقصا ) للناصري ( 1/ 124 ) .
[2][2] انظر: ( وصف إفريقية)2/ 121. ترجمة: د. حجي. و د. محمد الأخضر.
[3][3] انظر: ( الاستقصا )2/ 12.
[4][4] انظر: ( الدرر البهية في الفروع الحسنية والحسينية ) 1/63.
[5][5] انظر: ( صورة الأرض) ص:91.ط: بريل ،2. ليدن.1929.
[6][6] انظر: المعسول.6/23.
[7][7] من مقال قرظ به ذ. عبد القادر زمامة الفاسي. كتاب المعسول. للمختار السوسي. ن : المعسول.. 20/313.
[8][8] انظر: ( وصف إفريقية ). 2/127.
[9][9] انظر: الدرر..1 /63-64.
[10][10] انظر: الاستقصا 6/26. وشجرة النور الزكية 298.حيث يقول مؤلفها عن ابن أبي محلي المذكور:"كان من أعلام العلماء، والأئمة النبهاء، وأفراد الأذكياء ".و وانظر:-أيضا- عن ابن أبي محلّي.. ( المعسول ) 16/269.
[11][11] انظر: المعسول..16/349
[12][12] انظر: سلوة الأنفاس1/3.
[13][13] انظر: نشر المثاني2/96.ط حجرية.
[14][14] انظر: ( الموسوعة المغربية، للأعلام البشرية والحضارية ) الملحق 1/62.
[15][15] انظر: الدرر..1/64.
[16][16] انظر: المعسول . 1/126.يقول الكتاني في ( سلوة الأنفاس..)1/216 عن عبد الرحمن بن عبد ا لواحد هذا.: "كان فقيها نبيها أستاذا مقرئا مجودا وجيها". ت: 1029.
[17][17] انظر: نشر المثاني 1/264. و2/ 167.وانظر –أيضا _ ( سلوة الأنفاس) 2/203
[18][18] انظر: الديباج المذهب في تراجم أعيان المذهب.2/137.
[19][19] انظر: فهارس الخزانة الحسنية 6/176 محمد العربي الخطابي.
[20][20] انظر: المصدر السابق6/156
[21][21]انظر: المصدر السابق. 6/250
[22][22] انظر: الأمصار، ذوات الآثار .191-192-393. و الإعلان والتوبيخ.للسخاوي ص665.
[23][23] انظر: ( سير أعلام النبلاء )
[24][24] انظر: سلوة الأنفاس..1/3
[25][25] انظر: بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام. لابن القطان الفاسي.تح:د. الحسين آيت سعيد. 1/105.
[26][26] انظر: سير أعلام النبلاء.8/85.
[27][27] انظر: الدرر..1/54.
[28][28] انظر: الاستقصا..7/5.
[29][29] انظر: التشوف..ً 98.
[30][30] انظر: المحاضرات..
[31][31] انظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم.للقرافي 1/..تح علوي بنصر.
[32][32] انظر: الدرر البهية والجواهر النبوية، في الفروع الحسنية والحسينية. 1/64.
[33][33] انظر: الديباج المذهب..2 /108.
[34][34] : ترتيب المدارك ج 4 ص 97 ط 2: وزارة الأوقاف بالمغرب تح : عبد القادر الصحراوي. و انظر: خلاصة الأثر للخزرجي ص 422.
[35][35] انظر: ( الديباج المذهب..) 2/137. ولعل الاسم الصحيح ( أمدّكو) بتشديد الدال، وبدون تاء، الذي يعني في البربرية: الصاحب.
[36][36] انظر: التشوف إلى رجال التصوف 417.
[37][37] انظر:( دوحة الناشر بمحاسن أهل القرن العاشر) لابن عسكر الشفشاوني...ص 67. ط:حجرية. و( نوازل ابن هلال) ص 1.
[38][38] انظر: الكتاب المذكور ص-2- ط حجرية
[39][39] انظر: الكتاب المذكور ص-2- ط حجرية
[40][40] انظر: شجرة النور..268 .و الأعلام لخير الدين الزركلي . 1/78.ونيل الابتهاج، يتطريز اليباج.لأحمد بابا.1/66.طبع تحت إشراف عبد الحميد عبد الله الهرامة.والموسوعة المغربية.1/19.و3/35.ولقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد. لابن القاضي المكناسي.ص 276.وهو ثالث ثلاثة كتب. جمعها د .محمد حجي، في كتاب ( ألف سنة من الوفيات).
[41][41] انظر: الفكر السامي2/237.
[42][42] انظر: شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني ص15.
[43][43] انظر: نشر المثاني1 /264.
[44][44] انظر: المصدر السابق. 2/167.
[45][45] انظر: نشر المثاني..2/273.
[46][46] انظر: الفكر السامي..2/290.
[47][47] انظر: (الكتاب المذكور) ص2. ط:
[48][48] انظر: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع. لأبي محمد السجلماسي.قسم الدراسة ص 53 تح: علال الغازي.
[49][49] نشر المثاني 1/149.و ( سلوة الأنفاس ) 3/313.
[50][50] المصدر السابق. 2 /23.
[51][51] . المنزع البديع..54.
[52][52] انظر: ( الأعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام). 5/ 177.
[53][53] انظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة.2/164.
[54][54] فهو عنده : أبوبكر بن يحيى بن عبد الله الجذامي المالقي النحوي. المعروف بالخفاف.مات بالقاهرة في يوم السبت الثاني من رمضان. عام : 657.ن : (بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة).1/473.
[55][55] يقول ذ: علال الغازي : " ولا عجب فقد عودنا المترجمون، أن ينسبوا إلى هذه ( الأندلس) –كما ينعتها عبد الله كنون- ما ليس منها… ن : ( المنزع البديع..) ص 47. ومع هذا فلا يضيرنا أن يكون الخفاف سجلماسيا أو أندلسيا لشعورنا بأن الأندلس والمغرب بلد واحد – ولا سيما في باب العلوم-.
[56][56] انظر: مقدمة ( غرر المقالة في شرح غريب الرسالة )لابن حمامة المغراوي السجلماسي.إعداد : د. الهادي حمو. ود. محمد أبو الأجفان.
[57][57] انظر: كشف الظنون2/1780.
[58][58] انظر: إضاءة الأدموس ص 2.ط : حجرية.
[59][59] انظر: ( المعسول..) 6/ 32-52.
[60][60] انظر: المعسول..16/347..
 Commentaires textes : Écrire
Commentaires textes : Écrire

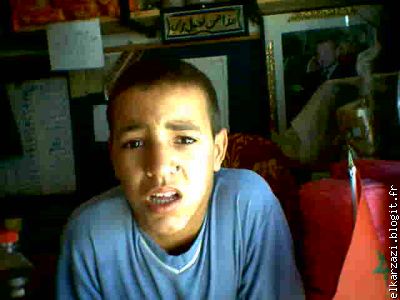




Lire les commentaires textes
what i want to say here is: football is the beuatiful sport among others